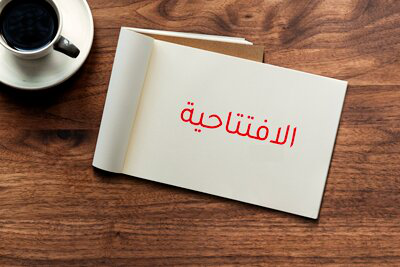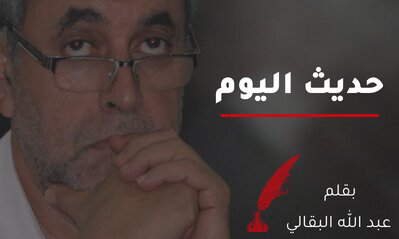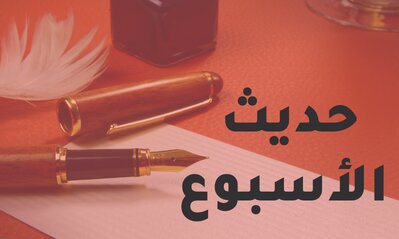*بقلم // الدكتور لحسن الياسميني*
يعد أبو حامد الغزالي وأبو الوليد ابن رشد من أبرز الأعلام الذين صاغوا ملامح الجدل الفلسفي والكلامي في الثقافة الإسلامية الوسيطة. وقد ارتبط اسماهما تاريخياً بمواجهة فكرية حادة، حيث اتهم الغزالي الفلاسفة بالكفر في قضايا جوهرية ضمن كتابه تهافت الفلاسفة، فرد عليه ابن رشد بكتابه تهافت التهافت مدافعاً عن الفلسفة ومنهجها البرهاني. ومع ذلك، فإن المفارقة التي تستوقف الباحث المتأمل أن الخصمين، ورغم الاختلاف العميق بينهما، قد اتفقا في مسألة دقيقة تتعلق بحدود المعرفة وإشاعة التأويل بين الخاصة والعامة.
لقد رأى الغزالي أنّ كشف أسرار التأويل للعوام خطأ جسيم يؤدي إلى اضطراب إيمانهم وتشويش عقيدتهم، ولذلك نص في كتابه إلجام العوام عن علم الكلام قائلاً: «فإياك أن تظن أن كشف هذه الأسرار للعوام مما يجوز… بل إخفاؤها عنهم واجب، كما يجب إخفاء بعض أصناف العلوم عن غير أهلها» (إلجام العوام عن علم الكلام، ص 39). بل إنه شدد في المضنون به على غير أهله على أنّ بعض العلوم لا يجوز كتابتها ولا ذكرها إلا لأهلها قائلاً: «فأما علم المكاشفة فليس يجوز أن يكتب، ولا أن يُذكر، ولا أن يُصرَّح به، لما فيه من الضرر على غير أهله» (المضنون به على غير أهله، ص 12). يظهر من ذلك أن الغزالي قد تبنى رؤية هرمية للمعرفة، تقوم على التفريق بين طبقة خاصة مؤهلة للغوص في المعاني الباطنة، وطبقة عامة يكفيها الوقوف عند ظاهر النصوص.
أما ابن رشد، الذي خالف الغزالي في موقفه من الفلسفة برمتها، فلم يختلف معه في شأن حجب التأويل عن الجمهور. ففي فصل المقال يؤكد أن النصوص الشرعية تحتمل ظاهراً وباطناً، لكن التصريح بالباطن للجمهور محظور لأنه يؤدي إلى انهيار إيمانهم، فيقول: «إن التأويل لا ينبغي أن يصرَّح به للجمهور، ولا أن يكتب فيه إلا للعلماء… فمن صرّح به لهم فقد دعاهم إلى الكفر» (فصل المقال، ص 45). بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال بوضوح: «من قال بالتأويل للعامة فهو كافر بإجماع» (فصل المقال، ص 46). فابن رشد، رغم دفاعه المستميت عن الفلسفة ضد الغزالي، لم يتردد في اعتبار التصريح بالتأويل لغير أهله جريمة معرفية وخطراً يهدد استقرار الجماعة.
ومع ذلك، لا ينبغي أن يُفهم هذا النهج في كتمان المعرفة على أنه استعلاء من الفلاسفة على العامة أو نوع من الترفع، بل كان منسجماً مع تصورهم لطبائع الناس واختلاف قدراتهم. فقد كانوا يعتقدون أن لكل طبقة اجتماعية خطاباً يتناسب مع بنيتها العقلية: فالعامة تُخاطب بالخيال والخطابة، وأهل النظر يُخاطبون بالجدل، أما الخاصة من الفلاسفة فيخاطبون بالبرهان. يقول الغزالي في إحياء علوم الدين: «الناس كالأطفال لا يطيقون ثقل الحقائق، فينبغي أن يُخاطب كل واحد على قدر عقله» (إحياء علوم الدين، ج 1، ص 34). ويقرر ابن رشد في فصل المقال: «إن طرق الناس في التصديق ثلاثة: برهانية وجدلية وخطابية، والشرع جاء بجميعها على حسب طبقات الناس، فمن الناس من يصدق بالبرهان، ومنهم من يصدق بالجدل، ومنهم من يصدق بالخطابة» (فصل المقال، ص 43).
ومن هنا يتضح أن موقف الغزالي وابن رشد لم يكن تعالياً بقدر ما كان تعبيراً عن إيمان عميق بأن كل طبقة اجتماعية لا تُقنع إلا بخطاب معين، وأن العوام – ومنها عوام المجتمعات العربية والإسلامية – ميالون أكثر إلى الخطاب التخيلي. وقد لاحظ ابن خلدون هذا الميل بوضوح، حين أشار إلى أن المؤرخين كثيراً ما ملؤوا كتبهم بالخوارق والمبالغات في أعداد الجيوش والأسرى وغيرها، وهو ما يكشف عن قوة سلطان الخيال في تشكيل قناعة الجمهور.
هذا الالتقاء بين الغزالي وابن رشد يكشف أن الخلاف حول الفلسفة لم يمنعهما من التوافق على ضرورة حجب بعض أشكال المعرفة. فالاثنان تبنيا المبدأ نفسه من منطلقين مختلفين: الغزالي بدافع الحرص على سلامة العقيدة، وابن رشد انطلاقاً من منطق فلسفي وسياسي يجعل من ضبط المعارف شرطاً لحفظ النظام العام. ففي إلجام العوام نقرأ للغزالي: «يجب على كل عالم أن يُلجِم العوام عن علم الكلام» (ص 7)، بينما يقرر ابن رشد أن من يصرّح بالتأويل للعامة «كافر بإجماع» (فصل المقال، ص 46). إنهما صوتان متباينان في المقدمات، متوافقان في النتيجة.
ومن هنا يتبين أن الموقف المشترك من الخاصة والعامة في باب التأويل ليس عرضياً، بل يعكس بنية فكرية عميقة في الثقافة.
وفي العصر الحديث والمعاصر، وإن كان تطور وسائل الاتصال قد أشاع المعرفة على نطاق واسع، فإنه لم يقتصر أثره على توسيع دائرة المتعلمين فحسب، بل منح جميع الطبقات، مهما كانت مراتبها العلمية وطرق استدلالها، فرصة التفكير والخوض في النقاش كما لو كانوا أهل البرهان. هذا الانفتاح ألغى إلى حد كبير الحدود التقليدية بين العامة والخاصة في التعامل مع المعرفة، وأوجد خلطاً بين مستويات الفهم والتقدير، فصار الرأي العام يستند في جزء كبير منه إلى أراء العوام، ويختلط فيه الخطاب التخيلي بخطاب الجدل والبرهان.
مع ذلك، يبقى الفرق بين طرق التفكير المختلفة قائماً، فلا يزال بعض الناس يميلون إلى التصديق بالخيال والخطابة، كما كان الحال لدى العوام في المجتمعات التقليدية، في حين يتطلب فهم بعض القضايا الجدلية أو العلمية القدرة على البرهان والتحليل المنطقي. هذا التباين يعقد مهمة التواصل المعرفي ويزيد صعوبة بناء فهم موحد أو رأي عام مستنير، حتى مع توفر المصادر والمعلومات للجميع. فالأمر ليس مسألة توصيل المعلومات فحسب، بل يتعلق بقدرة كل فرد على استيعابها وفق مستوى تحليله العقلي وطريقة استدلاله.
وهنا تتجلى المفارقة الكبرى: بينما كانت مقاربة الغزالي وابن رشد تهدف إلى حماية العقل والمجتمع عبر ضبط توزيع المعرفة بحسب قدرات المتلقين، فإن وسائل الاتصال الحديثة خلقت بيئة تبدو فيها المعرفة متاحة للجميع، لكنها في الواقع عرضة للاختلاط وسوء الفهم بسبب استمرار الفروق في طرق التفكير، مما يجعل ضمان دقة الفهم والمعرفة تحدياً أكبر من أي وقت مضى.
للتواصل مع الكاتب:
lahcenyasmini@gmail.com
lahcenyasmini@gmail.com
 رئيسية
رئيسية 








 الرئيسية
الرئيسية