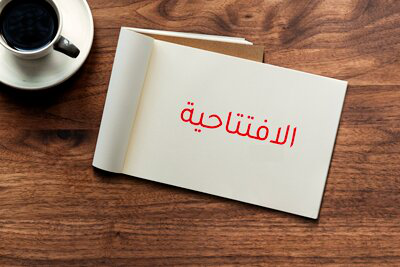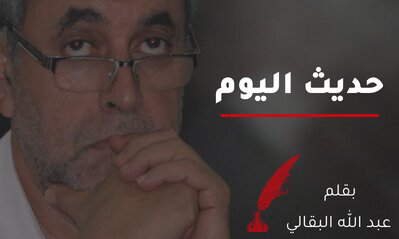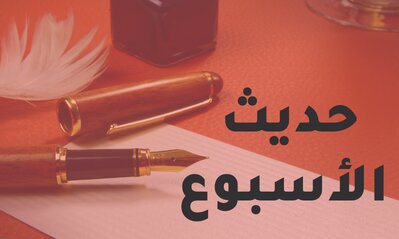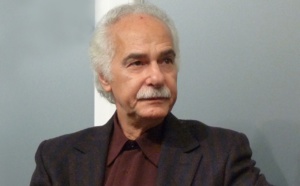في المجتمعات العربية، كثيراً ما يتردد الحديث عن اختلالات الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وعن الفساد والبيروقراطية والرداءة، ولكن ما لم يتم التوقف عنده بما يكفي من التأمل والتحليل هو ذلك التحول العميق الذي طرأ على هذه الأنظمة، حين انتقلنا من تفاهة النظام إلى نظام التفاهة. لم يعد الأمر مجرّد اختلالات ناتجة عن الارتجال أو الفشل في التدبير، بل صار التفاهة نفسها هي القاعدة، هي المنهج، هي الروح التي تسري في مفاصل المؤسسات والإعلام والتعليم والثقافة والدين. وهذا التحول خطير، لأنه لا يُنتج فقط واقعاً مختلاً، بل يُعيد تشكيل الوعي الجمعي على مقاسه، ويجعل من السطحية نمط تفكير ومن التفاهة أسلوب حياة.
في مراحل سابقة، حين كانت الأنظمة العربية تتخبط في الاستبداد وسوء التسيير، كانت التفاهة تُعتبر عرضاً جانبياً أو نتيجة طبيعية للفساد المستشري، للقرارات غير المدروسة، للوجوه المتكررة في المناصب رغم فشلها المزمن. كانت هناك تفاهة في الإدارة، في الخطاب، في الممارسة السياسية، ولكن مع ذلك، كان بالإمكان العثور على جيوب مقاومة داخل المؤسسات: أساتذة جامعيون يكتبون ويحللون، صحفيون يتحايلون على الرقابة، فنانين يرفضون الانخراط في التهريج، طلبة يناقشون في المقاهي والمنتديات، وجمهور لا يزال يميز بين القيمة الحقيقية والضجيج.
غير أن الزمن تغير، لا فقط لأن الأنظمة لم تتغير، بل لأنها أعادت هيكلة ذاتها لتُنتج نظاماً جديداً يُدير المجتمع لا بالاستبداد وحده، بل بالتفاهة. وهذا ما يجعلنا ننتقل إلى مرحلة أكثر خطورة: نظام التفاهة. هنا لم تعد الرداءة استثناء، بل أصبحت معياراً. لم تعد الكفاءة مطلوبة، بل صارت عبئاً. في هذا النظام، يُقصى العارف لأنه معقد، ويُحتقر المفكر لأنه مزعج، ويُهمّش المتخصص لأنه لا يتحدث بلغة السوق. النظام لم يعد ينتج الزعيم القوي أو الأب المتسلط أو الحزب الحديدي، بل يُنتج المؤثر، النجم اللحظي، الوجه المألوف الذي لا يقول شيئاً لكنه يملأ الفضاء العام حضوراً.
الإعلام في هذا السياق يلعب دوراً مركزياً. فهو لم يعد سلطة تراقب أو تحاسب أو تنور، بل أصبح هو المختبر الأول لصناعة التفاهة. البرامج الحوارية تُبنى على الإثارة، لا على الفكرة. المقدم الناجح هو من يستطيع رفع نسب المشاهدة، لا من يطرح الأسئلة الجادة. الضيوف يُنتقون بناء على قدرتهم على افتعال الجدل لا على عمق رؤيتهم. ومع منصات التواصل الاجتماعي، تضاعف هذا الأثر، حيث صار كل شيء قابلاً لأن يُستهلك سريعاً، حيث تتسابق العقول إلى التفاهة لا لأنها لا تعرف غيرها، بل لأنها صارت الطريق الأقصر نحو الشهرة والمال والقبول.
وما يحدث في الإعلام يُعاد إنتاجه في التعليم. لم تعد المدرسة مصنعاً للعقول، بل صارت مجرد إدارة تُلقن، تُعيد إنتاج البرامج، تُكافئ الانضباط وتُعاقب النقد. الطالب الجيد هو الذي يطيع، لا الذي يفكر. المعلم الجيد هو من لا يزعج الإدارة، لا من يطرح الأسئلة الكبرى. وتم إفراغ المناهج من المضامين الفكرية التي تُربي على التأمل، فاختفت الفلسفة أو ضُيّق الخناق عليها، وتراجعت العلوم الإنسانية لصالح تخصصات عملية تُنتج مهارات دون وعي. النتيجة جيل يعرف كيف يعمل، لكنه لا يعرف لماذا يعمل، جيل يعرف كيف ينجز مهمة، لكنه لا يطرح سؤال القيمة أو المعنى.
ولم يسلم الدين من هذا الزحف. بل لعل أكثر ما يدعو للقلق هو التحول في الخطاب الديني نفسه، حيث لم تعد القيم الروحية أو الأخلاقية هي جوهر الدعوة، بل صارت الفتاوى المثيرة، والنقاشات الهامشية، والمظاهر الاستعراضية هي ما يشغل الرأي العام. تحوّل بعض الدعاة إلى مشاهير، إلى نجوم على الشاشات، يكيفون رسائلهم حسب التوجهات السائدة، يختارون مواضيعهم بناء على نسب التفاعل، يتحدثون بلغة الجماهير لا بلغة الاجتهاد، فيضيع العمق، وتختفي القدوة، ويختلط الدين بالتسويق حتى لم نعد نميز بين الموعظة والإشهار.
نظام التفاهة لا يحكم فقط بمنطق الرداءة، بل يُنتج وعياً زائفاً يجعل من هذه الرداءة أمراً طبيعياً، بل محبّذاً. يُخلق نوع من التطبيع الجماعي مع الانحطاط، حيث لا يُستهجن شيء، ولا يُسائل أحد، ويُتهم من يخرج عن هذا القطيع بالسلبية أو بالتحذلق أو حتى بالخيانة. والناس، حين يعيشون لسنوات في هذا المناخ، يبدأون في التأقلم مع قلة الجودة، مع السطحية، مع العبث. يبدأون في تبرير الواقع بدل رفضه، في السخرية من المثقف بدل الإنصات له، في تمجيد التفاهة لأنها سهلة الهضم ولا تزعج الضمير.
وهنا تكمن خطورة نظام التفاهة: أنه لا يقتل الطموح فقط، بل يُصنع مجتمعات بلا أسئلة، بلا أفق، بلا ذوق جمالي أو حس نقدي. مجتمعات تشعر بالفراغ، لكنها لا تعرف سببه. تُعاني من الانهيار المعنوي، لكنها تواصل الضحك والمزاح والرقص على حافة الهاوية، كما لو أن السخرية وحدها كافية لستر العجز الجماعي. وحين تفقد المجتمعات بوصلتها، يصير كل شيء قابلاً للتسليع، حتى الإنسان، حتى الفكرة، حتى الألم.
ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذا المصير قدراً محتوماً. فكما أن التفاهة تنتشر بسهولة، فإن بذور الوعي تظل موجودة، حتى وإن بدت ضعيفة أو مبعثرة. في كل مجتمع، هناك دائماً من يقاوم، من يكتب رغم التعتيم، من يُعلّم رغم القمع، من يُفكر رغم الصخب، من يصرّ على أن يكون عميقاً في زمن السطحية. وهؤلاء، وإن بدوا أقلية، هم الأمل الحقيقي. لأن التغيير يبدأ دائماً من الهامش، من تلك النقطة الصغيرة التي تُصرّ على أن تقول: "هناك شيء خطأ، ويجب إصلاحه".
مهمتنا اليوم لا يجب أن تقتصر على تشخيص الداء، بل أن نُعيد الاعتبار لقيمة الفكر والمعنى، أن نُعلّم الأجيال الجديدة كيف تقرأ وتفكر وتنتقد، أن نُحيي الثقافة كمجال للارتقاء لا كوسيلة للتسلية، أن نُحرر الدين من الاستعراض، والإعلام من التهريج، والتعليم من التلقين. يجب أن نعيد زرع المعايير، لا لتقصي أحداً، بل لترفع الكل. لأن مجتمعات بلا معايير واضحة ستظل دوماً رهينة التفاهة، وستظل تدور في الفراغ، تستهلك كل شيء، دون أن تنتج شيئاً.
في مراحل سابقة، حين كانت الأنظمة العربية تتخبط في الاستبداد وسوء التسيير، كانت التفاهة تُعتبر عرضاً جانبياً أو نتيجة طبيعية للفساد المستشري، للقرارات غير المدروسة، للوجوه المتكررة في المناصب رغم فشلها المزمن. كانت هناك تفاهة في الإدارة، في الخطاب، في الممارسة السياسية، ولكن مع ذلك، كان بالإمكان العثور على جيوب مقاومة داخل المؤسسات: أساتذة جامعيون يكتبون ويحللون، صحفيون يتحايلون على الرقابة، فنانين يرفضون الانخراط في التهريج، طلبة يناقشون في المقاهي والمنتديات، وجمهور لا يزال يميز بين القيمة الحقيقية والضجيج.
غير أن الزمن تغير، لا فقط لأن الأنظمة لم تتغير، بل لأنها أعادت هيكلة ذاتها لتُنتج نظاماً جديداً يُدير المجتمع لا بالاستبداد وحده، بل بالتفاهة. وهذا ما يجعلنا ننتقل إلى مرحلة أكثر خطورة: نظام التفاهة. هنا لم تعد الرداءة استثناء، بل أصبحت معياراً. لم تعد الكفاءة مطلوبة، بل صارت عبئاً. في هذا النظام، يُقصى العارف لأنه معقد، ويُحتقر المفكر لأنه مزعج، ويُهمّش المتخصص لأنه لا يتحدث بلغة السوق. النظام لم يعد ينتج الزعيم القوي أو الأب المتسلط أو الحزب الحديدي، بل يُنتج المؤثر، النجم اللحظي، الوجه المألوف الذي لا يقول شيئاً لكنه يملأ الفضاء العام حضوراً.
الإعلام في هذا السياق يلعب دوراً مركزياً. فهو لم يعد سلطة تراقب أو تحاسب أو تنور، بل أصبح هو المختبر الأول لصناعة التفاهة. البرامج الحوارية تُبنى على الإثارة، لا على الفكرة. المقدم الناجح هو من يستطيع رفع نسب المشاهدة، لا من يطرح الأسئلة الجادة. الضيوف يُنتقون بناء على قدرتهم على افتعال الجدل لا على عمق رؤيتهم. ومع منصات التواصل الاجتماعي، تضاعف هذا الأثر، حيث صار كل شيء قابلاً لأن يُستهلك سريعاً، حيث تتسابق العقول إلى التفاهة لا لأنها لا تعرف غيرها، بل لأنها صارت الطريق الأقصر نحو الشهرة والمال والقبول.
وما يحدث في الإعلام يُعاد إنتاجه في التعليم. لم تعد المدرسة مصنعاً للعقول، بل صارت مجرد إدارة تُلقن، تُعيد إنتاج البرامج، تُكافئ الانضباط وتُعاقب النقد. الطالب الجيد هو الذي يطيع، لا الذي يفكر. المعلم الجيد هو من لا يزعج الإدارة، لا من يطرح الأسئلة الكبرى. وتم إفراغ المناهج من المضامين الفكرية التي تُربي على التأمل، فاختفت الفلسفة أو ضُيّق الخناق عليها، وتراجعت العلوم الإنسانية لصالح تخصصات عملية تُنتج مهارات دون وعي. النتيجة جيل يعرف كيف يعمل، لكنه لا يعرف لماذا يعمل، جيل يعرف كيف ينجز مهمة، لكنه لا يطرح سؤال القيمة أو المعنى.
ولم يسلم الدين من هذا الزحف. بل لعل أكثر ما يدعو للقلق هو التحول في الخطاب الديني نفسه، حيث لم تعد القيم الروحية أو الأخلاقية هي جوهر الدعوة، بل صارت الفتاوى المثيرة، والنقاشات الهامشية، والمظاهر الاستعراضية هي ما يشغل الرأي العام. تحوّل بعض الدعاة إلى مشاهير، إلى نجوم على الشاشات، يكيفون رسائلهم حسب التوجهات السائدة، يختارون مواضيعهم بناء على نسب التفاعل، يتحدثون بلغة الجماهير لا بلغة الاجتهاد، فيضيع العمق، وتختفي القدوة، ويختلط الدين بالتسويق حتى لم نعد نميز بين الموعظة والإشهار.
نظام التفاهة لا يحكم فقط بمنطق الرداءة، بل يُنتج وعياً زائفاً يجعل من هذه الرداءة أمراً طبيعياً، بل محبّذاً. يُخلق نوع من التطبيع الجماعي مع الانحطاط، حيث لا يُستهجن شيء، ولا يُسائل أحد، ويُتهم من يخرج عن هذا القطيع بالسلبية أو بالتحذلق أو حتى بالخيانة. والناس، حين يعيشون لسنوات في هذا المناخ، يبدأون في التأقلم مع قلة الجودة، مع السطحية، مع العبث. يبدأون في تبرير الواقع بدل رفضه، في السخرية من المثقف بدل الإنصات له، في تمجيد التفاهة لأنها سهلة الهضم ولا تزعج الضمير.
وهنا تكمن خطورة نظام التفاهة: أنه لا يقتل الطموح فقط، بل يُصنع مجتمعات بلا أسئلة، بلا أفق، بلا ذوق جمالي أو حس نقدي. مجتمعات تشعر بالفراغ، لكنها لا تعرف سببه. تُعاني من الانهيار المعنوي، لكنها تواصل الضحك والمزاح والرقص على حافة الهاوية، كما لو أن السخرية وحدها كافية لستر العجز الجماعي. وحين تفقد المجتمعات بوصلتها، يصير كل شيء قابلاً للتسليع، حتى الإنسان، حتى الفكرة، حتى الألم.
ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذا المصير قدراً محتوماً. فكما أن التفاهة تنتشر بسهولة، فإن بذور الوعي تظل موجودة، حتى وإن بدت ضعيفة أو مبعثرة. في كل مجتمع، هناك دائماً من يقاوم، من يكتب رغم التعتيم، من يُعلّم رغم القمع، من يُفكر رغم الصخب، من يصرّ على أن يكون عميقاً في زمن السطحية. وهؤلاء، وإن بدوا أقلية، هم الأمل الحقيقي. لأن التغيير يبدأ دائماً من الهامش، من تلك النقطة الصغيرة التي تُصرّ على أن تقول: "هناك شيء خطأ، ويجب إصلاحه".
مهمتنا اليوم لا يجب أن تقتصر على تشخيص الداء، بل أن نُعيد الاعتبار لقيمة الفكر والمعنى، أن نُعلّم الأجيال الجديدة كيف تقرأ وتفكر وتنتقد، أن نُحيي الثقافة كمجال للارتقاء لا كوسيلة للتسلية، أن نُحرر الدين من الاستعراض، والإعلام من التهريج، والتعليم من التلقين. يجب أن نعيد زرع المعايير، لا لتقصي أحداً، بل لترفع الكل. لأن مجتمعات بلا معايير واضحة ستظل دوماً رهينة التفاهة، وستظل تدور في الفراغ، تستهلك كل شيء، دون أن تنتج شيئاً.
 رئيسية
رئيسية 








 الرئيسية
الرئيسية