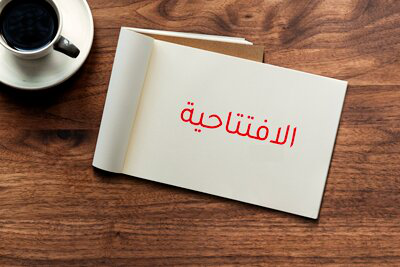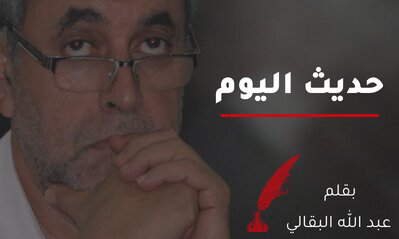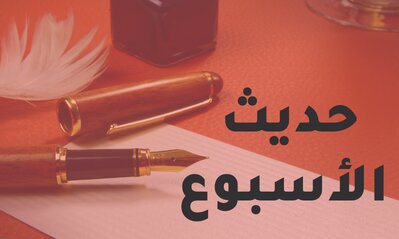الإنكار تحول إلى سلوك أساسي لجزء كبير من الطبقة السياسية خاصة تلك التي تمسك بمقاليد السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية وجزء كبير من دول الغرب.
سياسة الإنكار، في سياق العلاقات الدولية والعمليات السرية، تشير إلى ممارسة إخفاء الحقائق أو التنصل من المسؤولية عن عمل أو حدث معين، خاصة عندما يكون هذا العمل أو الحدث مثيرا للجدل أو يتعارض مع القيم المعلنة للدولة أو المنظمة.
إن مجريات الأحداث التي نعيشها اليوم تؤشر إلى نهاية المركزية الغربية، على الرغم من رفض الدول الغربية هذه الفكرة، وتصرفاتهم وتصريحاتهم التي تشي بالوهم الذي ما زال يعتري عقولهم بأنهم هم مركز الكون.
تقول الباحثة تيريزا كرم أن الإنكار هو إحدى الآليات النفسية التي يلتجأ إليها للتهرب من مواجهة الحقائق غير المريحة، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع. يتمثل الإنكار في رفض الإعتراف بحقائق مهددة أو مؤلمة، ويعتبر نوعا من الحماية النفسية التي تسمح للفرد بالتكيف مع الواقع بطرق قد تكون غير صحية على المدى الطويل. ومع مرور الزمن، تطور الإنكار ليأخذ أشكالًا أكثر تعقيدا، ليصبح أداة أيديولوجية تستخدم لأغراض سياسية أو اجتماعية لتشويه الحقائق أو تحريفها. وبذلك، يتحول الإنكار إلى آلية تؤثر في المجتمعات والسياسات بشكل أوسع. وقد أثبت العديد من الدراسات النفسية والإجتماعية أن الإنكار ليس مجرد ظاهرة فردية، بل إنه يمكن أن يصبح ظاهرة جماعية، تؤثر على مجموعة من الناس أو حتى على دول بأكملها.
إلى جانب كونه آلية فردية، يتحول الإنكار في بعض الأحيان إلى ظاهرة جماعية. وتظهر الأبحاث أنّ المجتمعات أحيانا تنكر الحقائق الكبيرة تحت ضغوط سياسية أو إجتماعية.
منذ أكثر من 22 شهرا تشن إسرائيل التي جندت عشرات الألاف من الجنود وحشدت مئات الدبابات والمدرعات وأحدث الطائرات بدعم غربي، حرب إبادة ضد سكان غزة ولكنها لم تستطع رغم مئات التصريحات والبلاغات من كسر شوكة المقاومة الفلسطينية، ومع انتصاف صيف 2025 خرجت تل أبيب بمشروع احتلال غزة بالكامل وكأنها كانت طوال الأشهر الماضية لا تحاول غير ذلك.
في لبنان تضغط واشنطن ولندن وباريس وبرلين على بيروت من أجل نزع سلاح حزب الله بدعوى أن ذلك سيقود إلى ترسيخ الأمن، رغم أنهم يدركون أنه لولا قوة حزب الله لما ظل لبنان ساحة صعبة ومكلفة لتل أبيب منذ ربع قرن رحلت القوات الإسرائيلية تحت جنح الظلام من جنوب لبنان في 25 مايو 2000 تحت تأثير ضربات المقاومة اللبنانية الإسلامية وأفواج المقاومة اللبنانية في حركة أمل مما تسبب في انهيار جيش لبنان الجنوبي العميل ودخول حزب الله إلى مناطق الجنوب وتشكيل خط دفاعي حمى لبنان من البطش الإسرائيلي.
في سوريا يتخبط المحافظون الجدد في مخططات التقسيم وإشعال الصراعات الطائفية ويسعون إلى احتلال مزيد من الأراضي بواسطة إسرائيل، ولكنهم يدركون أن مساعيهم تصطدم بمصاعب كبيرة.
عن إيران تحدثوا في تل أبيب وواشنطن عن النجاح في تدمير قدرات طهران النووية بعد الغارات الإسرائيلية الأمريكية التي بدأتها تل أبيب فجر 13 يونيو 2025 واستمرت 12 يوما، ولكن بعد وقف اطلاق النار بأيام كشفت الخديعة وتبين حسب مصادر غربية وثيقة أن طهران لا تزال قادرة على صنع سلاح نووي وأنها ربما أنجزت ذلك.
في وسط شرق أوروبا حيث دخلت الحرب بين روسيا وحلف الناتو سنتها الرابعة وأصبحت موسكو تسيطر على الساحة وتتقدم على طول جبهة طولها 1000 كيلومتر، لا يزال بعض الساسة الغربيين يتحدثون عن هزيمة روسيا. الرئيس ترامب أعطى مهلة 50 يوما للكرملين لقبول وقف إطلاق النار مع كييف، ثم عدل التوقيت إلى 10 أيام انتهت في 8 أغسطس 2025، ولكن الصورة تبدلت وأصبح هناك مخطط لقمة روسية أمريكية في ولاية ألاسكا منتصف شهر أغسطس.
هددت واشنطن كل من يتعامل اقتصاديا وتجاريا مع الكرملين ويشتري نفط روسيا، فلم تلق سوى التجاهل والرفض خاصة من جانب الهند 1451 مليون نسمة والبرازيل 212 مليون نسمة والصين 1409 مليون نسمة وغالبية دول بريكس 3625 مليون نسمة.
في واشنطن تسود فوضى التصريحات والتهديدات التي تتبدل وتتقلب من ساعة إلى أخرى.
توعدت واشنطن بتدمير الصين اقتصاديا وشنت حرب التعريفات الجمركية وفي النهاية تراجعت وتسعى لحل، في وقت يستمر اليمين الأمريكي في الدعوة إلى حرب كبرى للحفاظ على النظام العالمي الذي يتحكم فيه الغرب.
فخ استراتيجي
أفادت القناة "13 الإسرائيلية" أن الحكومة الإسرائيلية صادقت يوم الأحد 10 أغسطس على تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، بعد مصادقتها في وقت سابق على خطة لاحتلال غزة، في حين يسابق الوسطاء الزمن بحثاً عن اتفاق جديد.
وذكرت القناة أن خطة توسيع العملية تتضمن استخدام نيران كثيفة وتنفيذ عمليات قضم لأحياء بمدينة غزة.
وأضافت أن كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي وجهوا انتقادات حادة للعملية العسكرية المرتقبة في غزة، في حين نقلت القناة 12 عن ضباط كبار بالجيش أن الحرب عالقة وأصبحت مثل عربة تغوص في الرمل.
وبدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال قطاع غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني يوم الجمعة 8 أغسطس، بينما أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الخطة تواجه عدة تحديات.
وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماع المجلس الأمني امتد 10 ساعات، وشهد نقاشاً حاداً عبّر خلاله قادة الأجهزة الأمنية عن معارضتهم لاحتلال غزة بدرجات متفاوتة، مؤكدين وجود "خيارات أكثر ملاءمة" لتحقيق الأهداف نفسها.
وأكدت أن الاجتماع كان مسرحاً لخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير، كما واجه بعض الوزراء أيضا زامير بسبب موقفه.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن زامير وصف خطة احتلال غزة بـ"الفخ الإستراتيجي"، مؤكداً أنها ستنهك الجيش لسنوات، وتعرض حياة الأسرى للخطر.
ووفقا ليديعوت أحرونوت، قال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي خلال اجتماع الجمعة إن الصور التي نشرت مؤخراً لأسرى إسرائيليين تبدو عليهم آثار الهزال والمعاناة من الجوع لا تسمح له بدعم خطة "كل شيء أو لا شيء"، مضيفا "لست على استعداد للتنازل عن فرصة إنقاذ ما لا يقل عن 10 أسرى... وقف إطلاق النار سيمكننا من محاولة التوصل إلى اتفاق بشأنهم".
من جانبها، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نقص القوى العاملة من بين قيود رئيسية تواجه إسرائيل للسيطرة على غزة، وأوضحت أن العميد المتقاعد أمير أفيفي يرى أن التقدم السريع سيتطلب عدة فرق عسكرية تضم عشرات آلاف الجنود، وهو ما دفعه لترجيح اختيار عملية أكثر تدرجا تقلل الضغط على القوى البشرية.
وأوضحت أن جنودَ احتياط في الجيش الإسرائيلي هددوا بعدم العودة للقتال في غزة إذا تم استدعاؤهم مرة أخرى، في ظل حالة إرهاق واستنزاف يشهدها جيش الاحتلال بسبب طول أمد الحرب.
بحث عن اتفاق جديد
وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الولايات المتحدة والوسطاء يمارسون ضغوطاً على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وبدوره، نقل موقع "أكسيوس" أيضا عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الخطة الهجومية على غزة لن تنفذ على الفور، وإنه لم يحدد الجدول الزمني الدقيق لبدء العملية ما يترك مزيدا من الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي الكبير فإن نتنياهو تحدث بشكل غامض خلال اجتماع مجلس الوزراء، تاركاً الباب مواربا لوقف العملية، إذا استؤنفت المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى.
كتب الصحفي الإسرائيلي يوآف ليمور في يسرائيل هيوم:
ربما يتضح أن قرار الكابينيت احتلالَ مدينة غزة نقطة مفصلية، على الرغم من أنه ليس واضحا إلى أين سيؤدي، فبينما يهدف نتنياهو ووزراء الكابينيت إلى حسم مصير حركة «حماس»، يتزايد الخوف من أن القرار يمكن أن يحسم مصير إسرائيل نفسها.
وقد ظَهَرَ دليلان على ذلك في نهاية الأسبوع: الأول، قرار ألمانيا - أفضل وأقرب أصدقاء إسرائيل في أوروبا - فرضَ حظْرٍ على بيع الأسلحة التي يمكن أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة. والمعنى العملي للقرار محدود، لأن السلاح الأساسي الذي تشتريه إسرائيل من ألمانيا هو الغواصات، لكن معناه الحقيقي أكبر كثيراً، لأنه يمكن أن يقود إلى تسونامي خطِر.
بعكس الرأي السائد، أن إسرائيل يمكنها الاعتماد على السلاح الأمريكي وحده، فإن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعتمد أيضاً على العديد من الدول الأُخرى لشراء مكونات حيوية للمنظومات الاستراتيجية وتوريدها، وهذه الآن يمكن أن تكون في خطر، وهو ما يعني ضمنياً إضعاف القدرة الهجومية والدفاعية لإسرائيل.
أما الدليل الثاني، فكان في لقاء جرى في إيبيزا، في إسبانيا، بين الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف ورئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. ووفق التقارير، فقد ناقش الطرفان صفقة شاملة تؤدي إلى الإفراج عن جميع الأسرى وإنهاء الحرب، بهدف عرضها خلال أسبوعين على الأطراف المعنية، إلاّ إذا كان الأمر عبارة عن مؤامرة ذكية من بنيامين نتنياهو كي يجنب نفسه تعميق الحرب، ويمكن أن تجد إسرائيل نفسها أمام مطالبة من الرئيس ترامب بالتوصل إلى حل فوري.
إلى جانب الضغط الدولي المتزايد، الذي سيؤدي شهر سبتمبر المقبل إلى اعتراف متوقَع من دول رئيسية في العالم بدولة فلسطينية، ستسمع المطالبة بفرض إنهاء الحرب على إسرائيل، لكن ليس بالشروط التي تناسبها. وقد حذّر مسؤولون في المنظومتين الأمنية والدبلوماسية في الأيام الأخيرة من أن هذا يمثّل خطراً استراتيجياً على إسرائيل، لكن يبدو أن نتنياهو والوزراء تجاهلوا ما سمعوه، تماماً كما تجاهلوا الخشية من أن قرارهم يمكن أن يكلّف حياة أسرى وعدد كبير من الجنود. كما أنهم لم يتأثروا، على ما يبدو، بالتحذيرات بشأن تآكُل القوى البشرية في الجيش النظامي والاحتياط، وتراجع المخزون التسليحي، وطالبوا الجيش بأن يكون مطيعاً كالشرطة، وكان ذلك أحد التصريحات المذهلة التي قيلت في تلك الجلسة، إلى جانب توبيخ منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، بسبب مطالبته بأن تبقى إعادة الأسرى هدفاً أساسياً للحرب.
حرب لا نهاية لها
هذه المهمة بقيت فعلا ضمنَ المبادئ الخمسة التي حددها الكابينيت، وجاءت في المرتبة الثانية بعد نزع سلاح «حماس»، وتلي ذلك بنود كنزع سلاح القطاع، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على كل القطاع، ووجود إدارة مدنية بديلة في غزة لا تشمل «حماس» ولا السلطة الفلسطينية. هذه القرارات تمنح الحكومة مساحة كافية للاستمرار في حرب لا نهاية لها في غزة باسم الحاجة إلى جمع كل بندقية وقتل كل مقاتل، كما يمكن أن تقود إسرائيل إلى إدارة عسكرية مباشرة في القطاع، في غياب آلية إدارة بديلة.
في المبادئ التي حددت، لا توجد مكونات كـ «الاحتلال»، و«الطرد»، و«المدينة الإنسانية»، وهي مصطلحات ترددت مؤخرا بكثرة على لسان وزراء في الحكومة، ولا يعرف ما إذا تم حذفها بناءً على نصيحة قانونيين كبار حذروا في الأيام الأخيرة من أن إسرائيل تسير بوعي نحو وضع ستتهم فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وربما إبادة جماعية، أو نتيجة ضغط أمريكي. أما مَن لم يؤثروا في القرار، على ما يبدو، فهم رؤساء المنظومة الأمنية، الذين عارضوه بالإجماع، وحصلوا حتى على دعم نادر من رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، الذي خرج هذه المرة عن صفوف جوقة التشجيع لنتنياهو.
وعلى ما يبدو، فإن تحفُّظات قادة المنظومة الأمنية تقلق نتنياهو أقل من انتقادات وزراء اليمين، الذين يهددون دائما استقرار حكومته. واستنادا إلى التقارير، فقد اشتبك نتنياهو مع رئيس هيئة الأركان زامير في الجلسة، بعدما قال الأخير إن خطة نتنياهو (التي اعتمدت في النهاية) يمكن أن تكون «فخاً مميتاً». وزامير على حق طبعاً، فهذا لن يكون فخاً مميتاً فقط للأسرى، ولعدد كبير من الجنود، ولآلاف الفلسطينيين، بل أيضاً يمكن أن يكون مميتاً لدولة إسرائيل. ونتنياهو، كعادته، مقتنع بأنه سيعرف كيف يخرج من الورطة هذه المرة أيضاً، لكنه ربما يكتشف أنه ليس هاري هوديني، وأن إسرائيل ليست ساحة سيرك (حتى وإن كانت تتصرف أحياناً كأنها كذلك).
التعلُّم من التاريخ
أشار كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية في بداية أغسطس إلى تجاهل الخبرة التاريخية المتراكمة للأمريكيين في فيتنام، وأفغانستان، والعراق، وللروس في أفغانستان، وحتى للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. لم تنجح أي دولة في القيام بما يدعي الكابينيت أنه سينفذه الآن، وخصوصاً أن وراءنا فعلا عامين من الحرب التي أنهكت الجيش، بينما المجتمع منقسم، والشرعية الدولية في أدنى مستوياتها على الإطلاق.
زامير، صاحب الموقف الرافض بوضوح، يمكنه تأخير العملية بصورة كبيرة، فالجيش سيحتاج إلى عدة أسابيع للتخطيط، ثم إلى أسابيع إضافية لإجلاء سكان مدينة غزة (نحو مليون مدني) ولتجنيد قوات الاحتياط التي ستضطر إلى العودة مجدداً في فترة الأعياد، خلافاً للوعود بتقصير الخدمة. كما أن اعتقال المتهربين من الخدمة من الجمهور الحريدي يمثّل دائماً ورقة ضغط في يد زامير ورئيس شعبة القوى البشرية، اللواء دادو بار كليفا، من أجل الوقوف في وجه المنظومة السياسية.
الوقت الطويل والتحديات العديدة في الطريق – إلى جانب الضغط الدولي المتوقَع – سيوفران كثيراً من الفرص لتغيير الاتجاه، كما يشتبه وزراء اليمين في أن نتنياهو يعتزم القيام بذلك. وربما يطرح من جديد على الطاولة إمكان التوصل إلى اتفاق جزئي، على الرغم من أن إسرائيل تبدو وكأنها وضعت نفسها في موقف «الكل أو لا شيء»، وإذا لم يتراجع نتنياهو ويستمع إلى مَن يسعون لمصلحة إسرائيل في الداخل والخارج، فيمكن أن يقود إسرائيل في النهاية إلى أن تبقى بلا شيء.
توزيع مهام
جاء في بحث نشر على الشبكة العنكبوتية:
لضمان استمرار تفوقها، دعمت واشنطن قيام نمط اقتصادي عالمي جديد، يحتاج إلى طاقة من الشرق الأوسط، وصناعة منخفضة التكلفة من شرقي آسيا. وضمن هذا النظام، احتفظت الولايات المتحدة لنفسها بالموقع التكنولوجي والإداري والمالي، مما أبقى على هيمنتها المركزية.
أدى هذا الترتيب إلى اعتماد عالمي على منظومة تقودها واشنطن، واستخدمت فيه مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية كأذرع ناعمة لترسيخ النفوذ. لاحقًا، لعبت دول كاليابان، وكوريا الجنوبية، دورا في تحقيق توازن صناعي يخدم الرؤية الأمريكية الشاملة، بينما بقي الشرق الأوسط مركزا للطاقة، وميدانا دائما للصراعات التي تضمن الحاجة إلى الهيمنة الغربية.
أثبت النموذج الصيني قدرته على تحقيق التنمية الاقتصادية السريعة والفعالة، دون الحاجة إلى تبني الديمقراطية الغربية. هذا الطرح يمثل تحديا جوهريا للأسس الفكرية والسياسية التي قامت عليها الهيمنة الغربية، لأنه يقوض الثقة بأن الرأسمالية والازدهار مرتبطان حتما بالنموذج الديمقراطي الليبرالي. الصين بهذا تقدم بديلًا مغريا للعديد من الدول النامية التي تسعى إلى التطور السريع دون الخضوع لتكاليف التحول الديمقراطي.
فببراعتها في استغلال حاجة الرأسمالية العالمية إلى التكاليف المنخفضة، أصبحت الصين اليوم اللاعب الأكثر تهديدا للمكانة الأمريكية، فهي لا تنافس الولايات المتحدة من خارج النظام العالمي، كما فعل الاتحاد السوفياتي سابقا، بل من داخله، مسخرة آلياته لتحقيق صعودها الخاص.
والأخطر من ذلك، أن الصين قد تحولت من مجرد "مصنع العالم" إلى منافس جاد في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والابتكار الرقمي، مما يزعزع التفوق التاريخي للولايات المتحدة في هذه الميادين، وهذا يشكل خطرا كبيرا على الهيمنة الغربية الأمريكية على العالم ككل، وليس فقط على المجالات الاقتصادية أو التقنية المحددة.
وهي لا تستنزف نفسها في الحروب والصراعات العسكرية المباشرة. بدلا من ذلك، تراكم قوتها بهدوء عبر النمو الاقتصادي، ومبادرات مثل "الحزام والطريق"، وبناء شبكة واسعة من الشراكات العالمية التي تمتد إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية، مؤسسة بذلك لنظام عالمي مواز ونفوذ متنام.
بما أن الصين تمثل المنافس الحقيقي والأكثر جدية في الصراع العالمي على الهيمنة، فإن الولايات المتحدة تسعى على الأرجح إلى حسم الصراعات في مناطق أخرى قبل خوض هذه المعركة الكبرى في تايوان
يظهر أن معركة ترامب ليست فقط حول رئاسة أو حزب، بل حول هوية دولة ودور عالمي.. إننا أمام مفترق طرق تاريخي: إما أن تكون هذه اللحظة بداية نهاية الحقبة الأمريكية بصورتها القديمة، أو بداية إعادة تموضع عنيف تحاول فيه واشنطن، عبر شخصية ترامب أو غيره، إعادة رسم قواعد اللعبة الدولية على أسس جديدة أكثر قسوة وأقل تسامحا.
أفتكون رئاسته رقصة النهاية لإمبراطورية آيلة للسقوط، أم بداية لحقبة جديدة من السيطرة، بأدوات أكثر خشونة وأقل نفاقًا؟.
قمة قد لا تحل شيئا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيعقد في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة 15 أغسطس.
توقعات كثيرة تطرح حول نتائج اللقاء ومنها أنها قد لا تحل الصراع الأساسي في وسط شرق أوروبا وقد يتم فيها فقط الاتفاق على قضايا متنوعة وتمديد اتفاقيات خاصة بالأسلحة النووية.
يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أكد أن التحضيرات للقمة ستكون صعبة. وشدد على أن كلا الجانبين سيعملان بجد للوصول لنتائج في هذه القمة. وأضاف: “من المؤكد أن الرئيسين سيناقشون سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأجل حول الأزمة الأوكرانية”. وأشار أيضا إلى أن المصالح الاقتصادية لكلا البلدين تتلاقى في ألاسكا والمنطقة القطبية الشمالية. وهناك فرص واضحة لتنفيذ مشاريع كبيرة تعود بالفائدة على الجانبين.
وذكر أوشاكوف: “ستركز موسكو وواشنطن، خلال الأيام القليلة المقبلة، على وضع معايير عملية وسياسية محددة لقمة ألاسكا” ولكنه لم يتطرق إلى العقوبات التي يهدد بها ترامب موسكو، حسب ما نشرت تقارير إعلامية.
في موسكو أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما ليونيد سلوتسكي أن فرض عقوبات ثانوية واستخدام بكين ونيودلهي كأدوات للضغط على روسيا سيؤدي إلى هزيمة الولايات المتحدة في المواجهة السياسية.
وكتب النائب في قناته على "تلغرام": "سعي الأطلسيين لتحويل بكين ونيودلهي إلى 'أداة ضغط' على موسكو عبر فرض عقوبات ثانوية ورسوم جمركية محكوم بالفشل. من المستبعد أن تلعب الأغلبية العالمية وفق قواعد الأقلية الغربية. سيكون هذا ضربا من العبث".
وأشار سلوتسكي إلى أن الهند والصين ترفضان علنا الضغوط الأمريكية. فقد أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار أن العلاقات مع روسيا لها قيمتها المستقلة ولا يجب النظر إليها من منظور دول ثالثة. كما أن بكين ترفض باستمرار أي تدخل خارجي في علاقاتها الاقتصادية مع موسكو.
ويرى النائب أن العالم أحادي القطبية والنفوذ الغربي الهائل أصبحا من الماضي. وأكد سلوتسكي: "لا الصين ولا الهند ترغبان في دفع جزية للمتطلعين إلى الهيمنة أو التضحية بسيادتهما على مذبح 'الاستثناء الأمريكي'".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يبالي بما يجري اقتصاديا بين روسيا والهند وصرح بأن كل ما يرغبه هو رؤية اقتصاد هاتين الدولتين في الحضيض.
ومن خلال التصريحات الرسمية الأخيرة، يبدو أن ترامب قد وضع على جدول أعماله روسيا والهند لاستهدافهما باستراتيجيته التي تشغل اقتصاد العالم منذ وصول الأخير إلى البيت الأبيض عبر فرض الرسوم الجمركية.
وقال إنه "يحب الشعب الروسي" ولا يرغب في اللجوء إلى فرض قيود بسبب الوضع في أوكرانيا، لكنه أكد عزمه على فرض عقوبات ثانوية على موسكو في حال تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع الأوكراني.
وعلى صعيد متصل، أعلن ترامب عن عزمه فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المئة على الهند.
من جانبه صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الغرب الجماعي يسعى إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا باستخدام نظام كييف أداة للحرب، لكنه لن ينجح في ذلك.
وأضاف لافروف: "نشهد مواجهة غير مسبوقة لبلدنا مع الغرب الجماعي، الذي قرر مرة أخرى خوض حرب ضدنا وإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مستخدما النظام النازي في كييف لتحقيق ذلك".
وأضاف: "لم ينجح الغرب في ذلك قط - وسيفشل هذه المرة أيضا. ربما بدأوا يدركون ذلك".
في مقال بمجلة "ذا أمريكان كونسيرفاتيف" رأى الكاتب الأمريكي تيد سنيدر، ، أن حرب أوكرانيا ما كان يجب أن تندلع أصلا، فالولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي كان بإمكانهما تفادي الحرب عبر التفاوض المبكر مع روسيا، لكن بدلا من ذلك، اختارا التصعيد، و"إغراء" كييف بوعود لم تتحقق، أبرزها الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي، وهزيمة موسكو ميدانياً.
وبحسب الكاتب، فإن واشنطن ضغطت على كييف لرفض اتفاق سلام كان مطروحا في بداية الحرب، ليستبدَل بـ"نضال طويل" على أساس وعود لا تزال بعيدة المنال، بينما تدفع أوكرانيا الثمن الأكبر إنسانياً واقتصاديا واستراتيجيا.
صمود الاقتصاد
في بحث نشر في مجلة American Conservative نهاية شهر يوليو 2025 أشار دوغ باندو مساعد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان إلى أن الاقتصاد الروسي صمد أمام العقوبات الغربية ونما خلالها، محذرا من أثرها على من فرضوها.
وأشار باندو إلى أن العقوبات الجديدة ضد روسيا التي أعلن عنها الرئيس ترامب ستضر بواشنطن نفسها.
ففي 14 يوليو، هدد ترامب بأنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 100 في المئة على البضائع الروسية، بالإضافة إلى عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا خلال 50 يوما.
وأضاف باندو: "لقد صمد الاقتصاد الروسي في وجه العقوبات الغربية، بل وشهد نموا منذ بداية الحرب. إن تهديد ترامب بمعاقبة الدول التي تشتري النفط الروسي، وخاصة الصين والهند والبرازيل، من شأنه أن يضر بالولايات المتحدة لأنه من المستبعد أن تستسلم هذه الدول لضغوط واشنطن".
ويعتقد باندو أيضا أن مثل هذه الإجراءات التي يتخذها ترامب من شأنها أن تقوض العلاقات الآخذة في التحسن بين الولايات المتحدة والهند، وتقلل من فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، وتفاقم تناقضات واشنطن مع البرازيل.
وفي تعليقه على تهديدات ترامب بفرض تدابير تقييدية جديدة، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الاقتصاد الروسي قد اكتسب بالفعل مناعة ضد العقوبات الغربية.
الجغرافيا تقاتل مع روسيا
تعد روسيا أكبر دولة مساحة في العالم، بامتداد جغرافي يبلغ نحو 17 مليون كيلومتر مربع، مما يمنحها قدرة استثنائية على المناورة الإستراتيجية من أوروبا الشرقية إلى سواحل المحيط الهادي. وهي تتشارك حدودا برية أو بحرية مع 16 دولة، بعضها من الحلفاء النوويين، وأبرزهم الصين، ثاني أقوى قوة اقتصادية وعسكرية في العالم، بحدود يصل طولها إلى 4200 كيلومتر، إضافة إلى كوريا الشمالية، ثم إيران التي لا تشترك مع روسيا بحدود برية، لكنها ترتبط بها جغرافيا عبر بحر قزوين، وهو امتداد إستراتيجي لا يقل أهمية عن الحدود البرية من الناحية اللوجستية.
ومن ثم فلا يمكن إغفال الدور المحوري الذي أدته الجغرافيا في تعزيز قدرة روسيا على الصمود في وجه الحصار الغربي. فالدول المجاورة لها مباشرة، مثل الصين وكوريا الشمالية ومنغوليا، أو تلك التي ترتبط بها عبر حدود وسيطة، وفرت لها دعما متنوعا، سواء عبر الإمداد المباشر أو عبر توفير نقاط عبور إستراتيجية، بدوافع تتراوح بين المصالح الذاتية والعداء للغرب. هذا الامتداد الجغرافي الواسع، الذي يشمل قلب أوراسيا، يجعل من المستحيل عمليا فرض حصار شامل وفعال على روسيا.
ورغم أن بعض هذه الدول ليست داعمة لروسيا بشكل كامل، فإن امتناعها عن المشاركة في العقوبات الغربية، واحتفاظها بعلاقات اقتصادية وتجارية مع موسكو، يجعلها فعليا "حليفة بحكم الجغرافيا"، وكان التجلي الأبرز لهذا العمق الجغرافي هو مشاركة كوريا الشمالية بأكثر من 10 آلاف مقاتل لإسناد الجيش الروسي في استعادة منطقة كورسك.
الردع النووي
منذ الأيام الأولى للحرب، خيم شبح الخوف من التصعيد النووي على كل قرارات الغرب في معايرة الردود الممكنة على موسكو. وعلى الرغم من الإدانات والعقوبات والدعم العسكري الغربي الواسع لكييف، بقيت هناك "خطوط حمراء غير مرئية" تقيد السلوك الغربي، لمنع وقوع الخطر النووي.
تمتلك روسيا أكبر ترسانة نووية في العالم، وأكثر من 6 آلاف رأس نووي. ومنذ بداية الحرب، لمح الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولون روس إلى إمكانية استخدام السلاح النووي في حال "تهديد وجودي". هذا التهديد، وإن لم يكن صريحا، أجبر صناع القرار في واشنطن وبروكسل على التعامل مع موسكو بوصفها قوة ذات "حواجز خطيرة".
وإجمالا يمكن القول بأن الخوف من الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع قوة نووية، قيد خيارات الدول الغربية. فالولايات المتحدة والناتو كلاهما رفضا إقامة منطقة حظر جوي، أو إرسال قوات برية، أو تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى (في بداية الحرب) لضرب العمق الروسي. وحتى حين قدمت واشنطن لكييف صواريخ طويلة المدى (ATACMS)، فرضت شروطا حول استخدامها داخل الأراضي الروسية.
ربما كان توقع التهديد النووي مبالغا فيه، لكن احتمال استخدامه ليس صفرا، ويبدو أن بوتين راهن على أن مجرد التهديد بالغموض النووي كاف لشل إرادة الغرب في بعض الاتجاهات، وقد نجح.
أزمة الغرب
الأزمة السياسية في الغرب مصطلح واسع يشير إلى مجموعة من التحديات والتوترات التي تواجه الدول الغربية في الوقت الحالي. تشمل هذه التحديات: تأزم الوضع الاقتصادي وتزايد الشعبوية، والانقسامات الاجتماعية والسياسية العميقة، وتراجع الثقة في المؤسسات، وتزايد عدم المساواة، وتغير المناخ، وتداعيات جائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا. هذه العوامل مجتمعة تساهم في زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في الغرب. ومن الملفت أن النخب السياسية في الدول الغربية، وكذلك دارسو العلوم السياسة يقفون عاجزين أمام فهم هذه الأزمة، وذلك ربما لأنهم كانوا يؤمنون لفترة طويلة بأن الديمقراطية الليبرالية كما نشأت في الدول الغربية تمثل "نهاية التاريخ" أو النموذج الذي تتطلع له جميع دول العالم كما أدعى عالم السياسة الأمريكي "فرانسيس فوكوياما" بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.
أحد أهم دعامات القوى الغربية عالميا هي السيطرة المالية، والدولار الأمريكي هو أحد اعمدتها.
جاء في تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الامريكية بتاريخ 5 أغسطس 2025:
يواجه الدولار الأمريكي، إلى جانب الأصول المالية الأخرى في الولايات المتحدة، ضغوطا متزايدة قد تؤدي إلى موجات بيع جديدة، على خلفية مخاوف متصاعدة من تآكل مصداقية المؤسسات الاقتصادية الأمريكية، بحسب ما حذر منه محللون وإستراتيجيون اقتصاديون تحدثوا لوكالة "بلومبيرغ".
يأتي ذلك عقب استقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي أدريانا كوغلر يوم الجمعة 1 أغسطس، مما يمنح الرئيس الأمريكي ترامب فرصة لتعيين بديل لها، في وقت حساس من دورة السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما يهدد بتقليص نفوذ رئيس البنك المركزي جيروم باول.
وتزداد المخاوف بعد أن أقال ترامب أيضا رئيسة مكتب إحصاءات العمل، إريكا ماكنتارفر، وهي الخطوة التي يرى فيها المستثمرون تهديدا مباشرا لاستقلالية البيانات الاقتصادية الأمريكية، ما يزيد من حالة الشك المحيطة بمستقبل السياسة النقدية، ويضعف الثقة بالدولار والأصول المرتبطة به.
وصرح روبرت بيرغكفيست، كبير الاقتصاديين في بنك "سيب" في ستوكهولم: "للأسف، نحن نشهد محاولات جدية جديدة لتركيز السلطة أكثر فأكثر في يد البيت الأبيض"، مضيفا: "كل هذا يبرر رفع علاوة المخاطر على الأصول الأمريكية".
ورغم تسجيل الدولار انتعاشا طفيفا مطلع الأسبوع الماضي، فإنه هبط بشكل حاد يوم الجمعة مقابل جميع عملات مجموعة العشر، إثر صدور تقرير ضعيف للوظائف جاء دون التوقعات، ما دفع الأسواق إلى ترجيح خفض محتمل في أسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر المقبل.
ووفقا لبيانات منصة بلومبيرغ، فقد تراجع مقياس قوة الدولار الشاملة بنحو 8 في المئة منذ بداية عام 2025.
وصرح إلياس حداد، إستراتيجي في بنك "براون براذرز هاريمان" في لندن: "مصداقية صنع السياسة في أمريكا أصبحت مهددة بشكل متزايد"، مضيفا أن مساعي ترامب للضغط على باول وزملائه لتسريع خفض الفائدة "تقوض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي"، فيما "تضعف إقالة ماكنتارفر ثقة الأسواق بسلامة البيانات الاقتصادية الأمريكية".
وفي تحليل داخلي لبلومبيرغ، قال المحلل الإستراتيجي مارك كودمور "لا توجد طريقة إيجابية لتفسير قرار ترامب بإقالة رئيسة مكتب الإحصاءات. إما أن البيانات السابقة كانت مشوهة كما يدعي، أو أن البيانات كانت موثوقة حتى الآن، وأصبحت الآن عرضة للتسييس. في الحالتين، باتت البيانات المستقبلية مشكوكا فيها ويجب أن تُحمل علاوة مخاطر أكبر".
للتواصل مع الكاتب
عمر نجيب
Omar_najib2003@yahoo.fr
عمر نجيب
Omar_najib2003@yahoo.fr
 رئيسية
رئيسية 








 الرئيسية
الرئيسية