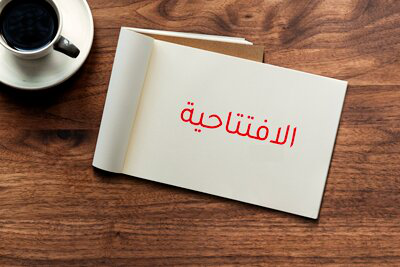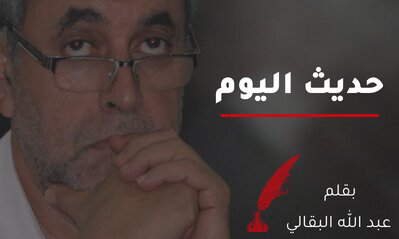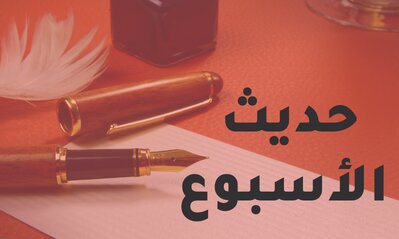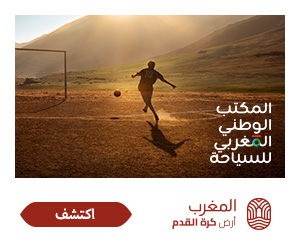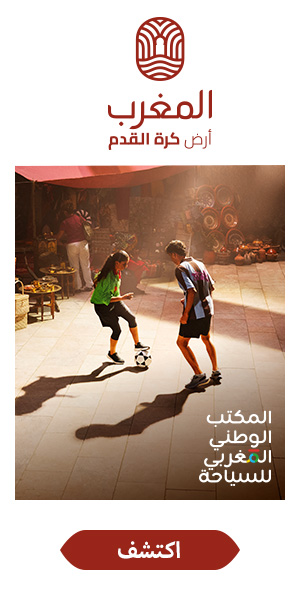*العلم الإلكترونية: الغبزوري السكناوي*
حين تطأ قدماك رمال شاطئ بادس، على أطراف إقليم الحسيمة، في عمق الريف المغربي المطِلّ على زرقة المتوسط، لا تجد لافتة تاريخية تعرفك بالمكان، ولا أي أثر رسمي يذكّرك بأنك تقف فوق تراب مدينة كانت يومًا مرسى للعلماء ومرفأ للوزراء. هنا، الصمت هو المستضيف الوحيد، وصدى البحر يرشد خطواتك. أمامك تمتد شبه جزيرة صخرية يتدلّى من أعلاها العلم الإسباني، وجنود يراقبون بهدوء حافة البحر. ما تراه مجرد واجهة، أما الحقيقة فهي أعمق: وجه المدينة مخبوء في الجذور، وتاريخها محفور في الصخر والسكينة.
في بادس، الأرض تخفي أكثر مما تظهر؛ الرمال تحوي أسرارًا مطمورة، والجبال تكتنز ظلال الأولياء، وعلى ضفافها ترسو المراكب القديمة محمّلة بأصداء معارك ومواويل مضت. هنا، كل زاوية تهمس بتاريخ لم يُكتب، وكل صخرة تنبض بما لم تسطره كتب المؤرخين. الذاكرة هنا أعمق من الكلمات وأثقل من أن تُروى دفعة واحدة. المكان لا يموت رغم صمته، ولا يتكلم إلا لمن ينصت له حقًا. أما العابرون فلا يدركون سوى قشرة الزمن، بينما الجوهر يختبئ في الأعماق، يخط نفسه بالحكاية والشعور لا بالخرائط.
هذا المكان ليس مجرد موقع جغرافي، بل قصة حياة كاملة تُروى. الحديث عن بادس قد نعني به الصخرة أو شبه الجزيرة، وقد نقصد المدينة التاريخية المطمورة، أو الشاطئ المنسوج من العزلة والجمال. نستعيد بادس كما هي في كتب الجهاد والصلاح والولاية، وفي ذاكرة التجارة والعلم والصناعة. رغم أن الحكايات لم تُكتب كلها، فإنها بقيت تُروى، وإن غابت في غبار الغزاة، لم تنطفئ، بل اختبأت في تضاريس الذاكرة، واستترت في ظل الصخر. هنا، تسافر الذاكرة بلا جواز، ويتحوّل المكان إلى كتاب مفتوح تترتله الطبيعة، وتكتبه الريح على الرمل، وتظل كل زفرة بحر قصيدة تنتظر من يصغي إليها، لا بالمداد، بل بالإنصات.

كيان في برزخ المعنى
في مشهد بصري نادر يأسر العين ويستفز الذاكرة، تتبدّى بادس كمقطوعة جغرافية مشبعة بالرموز: صخرة مائلة إلى البحر، كأنها قلعة عائمة فوق صفحة الماء، معلّقة بين البر والموج، لا تنتمي كليًّا إلى اليابسة ولا تغيب تمامًا في البحر. هذا الاشتباك الغريب بين اليابسة والبحر يجعلها عالقة في برزخ رمزي وجغرافي، توهم بالثبات، بينما تتفاعل في داخلها طبقات التاريخ والجغرافيا. صخرة "القُميرة La Gomera"، كما كانت تُعرف، لا يفصلها عن البر سوى أمتار قليلة، لكنها كافية لصنع مسافة منسية بين الحكاية والواقع، بين الوطن والاحتلال، بين ما يُرى وما يُخفيه الغياب.
غير بعيد عن هذه الصخرة، يتمدد السهل الذي يحتضن الشاطئ، وكأنه الجناح البريّ لمدينةٍ غابت تحت طبقات الزمن. لم يكن هذا الفضاء أرضًا بريّة عابرة، بل حاضنة لعمران وتعايش، ولحظات اتسعت للحياة، وانفتحت على تنوع الذاكرة.
هنا، امتزجت الذاكرة الأمازيغية والعربية والأندلسية، وتجاور المسلمون واليهود في أحياء عاش فيها الناس بتآلف طبيعي، يكتبون دون وعي فصولًا من تاريخ التعايش. ثم جاء الانكسار، فتراجع العمران، وانسحب التاريخ من المكان بهدوء. كأن السهل بقي يطلّ على البحر بعدهم، يتفقد وجوهًا لم تعد، ويتأمل صدى خطوات لم تترك أثرًا إلا في الرمل والحنين.
وبين الجبل والوادي، وبين السهل والصخرة، تتكوّن الصورة الكاملة لبادس: مدينة وُلدت على تخوم الإمبراطوريات، وعاشت على تخوم المعنى، وماتت واقفة في وجه الغزاة. صمتها ليس خواء، بل طبقات من الذاكرة والدهشة، من الحكايات التي لم تُكتب، والصور التي لم تكتمل. كل موجة تلامس رملها تستعيد همسًا من ماضٍ بعيد، وكل ظلّ يُلقى على صخرتها يُوقظ مشهدًا غائمًا من سردية ناقصة. لا تزال الحجارة تنطق بما لم يُسجّل، والرمال تحفظ أسماء الذين مرّوا، والبحر، وحده البحر، لم ينسَ أن هنا كان مرفأً للعلماء والمجاهدين، ومدينة تختصر الوطن في موجة وصخرة وسهل ينتظر من يعيد إليه النبض.

على تخوم الإمبراطوريات... وعتبة النسيان
بادس ليست مجرّد اسم في كتب التاريخ، بل كيان طبيعي مركّب، تتقاطع فيه الجغرافيا بالانتماء، والصخر بالذاكرة. تقع على بُعد 47 كيلومترًا غرب مدينة الحسيمة، في قلب المنتزه الوطني، وتحتضنها من الشرق زرقة شاطئ "ثارخسونت" الذي يفصلها عنه رأس "ن ثامزورث"، فيما تنتمي إداريًا بمعظم مساحتها إلى جماعة اسنادة، باستثناء الجهة الشرقية بمحاذاة مصب وادي "العنصر"، حيث تتبع جماعة الرواضي. في هذا الموقع الذي تلتقي فيه عناصر الماء والرمل والصخر، تنكمش الجغرافيا في حضن البحر، وتلتف الجبال والوديان حول المكان كما لو كانت تحرس سرًّا خفيًّا لا يُروى إلا همسًا.
في هذا الركن الهامشي، تقف بادس كقطرة ضوء على حافة النسيان، تتقاسمها الصخور والبحر، الجرف والوادي، ويشدّك من القلب منها منظر الصخرة المحتلة، شبه الجزيرة التي لا يفصلها عن اليابسة سوى أمتار قليلة، لكنها تحمل مسافة شاسعة بين السيادة والاحتلال، بين الذاكرة والجفاء. من هذا الحيز العالق بين اليابسة والماء، كانت المدينة تنبض في زمن مضى، كمرفأ للتجارة، وورشة لصناعة السفن، وملتقى للعلماء والمجاهدين والناس العابرين. لم تكن مجرد نقطة حراسة بحرية، بل فضاءً للعيش المشترك، حيث اختلطت الأمازيغية بالعربية، وتجاور المسلمون واليهود في تآلف نادر.
وهبت الجغرافيا بادس موقعًا فريدًا عند التقاء البحر بالجبل، لكن الذاكرة منحتها ما هو أعمق من التضاريس: سيرة مدينة خاضت صراعات الزمن، وبقيت متجذّرة في الضمير. لم تكن مجرد مرفأ، بل مرآة لمغرب يطلّ على العالم. عرفت أحيانًا بـ "مرفأ فاس" أو "مرفأ تازة"، لما كانت تلعبه من دور في ربط الداخل المغربي بشواطئ المتوسط. وفي لحظة المنفى والضيق، اتخذها ذو الوزارتين لسان الدين بن الخطيب مقامًا، وكتب في صمتها سينيته الخالدة. لم تكن المدينة تباهي فقط بموقعها، بل بصمتها التي تتكلّم بها الحجارة، وبحنين البحر الذي لا ينسى.

حين يختبئ التاريخ خلف الصخرة
يُقال إن بادس شُيّدت على أنقاض مدينة رومانية تُدعى برييتينا Praietina، وبلغت ذروة مجدها بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر، حين حصّنها السلطان الموحدي محمد بن يعقوب في القرن الثاني عشر، بأسوار كأنها أذرع حجرية تعانق البحر وتصدّ الغزاة. لكن الزمن لم يمهلها طويلًا؛ فمع انهيار الدولة الوطاسية وصعود السعديين، تحوّلت بادس إلى ساحة دماء تتنازعها الجيوش. وفي سنة 1564، اجتاحتها القوات الإسبانية، فسقطت تحت الاحتلال، لكنها لم تسقط من الوجدان، بل انسحبت إلى الصمت، متلفّحة بالحجر والانتظار.
لم تكن بادس مجرّد مرفأ عابر، بل عقدة وصل بين المغرب وآفاق المتوسط والمشرق. من مرافئها انطلقت السفن نحو تونس ومصر والشام، كما نحو إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. وكان ازدهارها مدعومًا بوفرة أخشابها، وكفاءة صنّاعها، خاصة في "دار الصنعة"، التي كانت من معالمها البارزة. هنا عاش الأندلسيون اليهود بعد سقوط غرناطة، واندمجوا في نسيج المدينة، كما لجأ إليها الثائرون على السلطان والفارّون من الممالك المسيحية، ومنهم منصور بن سليمان. لم تكن منفتحة على التجارة فقط، بل كانت منصّة للمعرفة، ولجدل الحياة والسلطة والروح.
في قلب صمتها، اختارها ذو الوزارتين لسان الدين بن الخطيب مقامًا حين ضاقت به الأندلس، فجلس يكتب من عند منحنى البحر سينيّته الشهيرة:
عَسَى خَطْرةٌ بالرّكْبِ يا حادِيَ العِيسِ
علَى الهضْبَةِ الشّمّا منْ قصْرِ بادِيسِ
لتَظْفَرَ منْ ذاك الزُّلالِ بعَلّةٍ
وتنْعَمَ في تِلْك الظِّلالِ بتَعْريسِ
علَى الهضْبَةِ الشّمّا منْ قصْرِ بادِيسِ
لتَظْفَرَ منْ ذاك الزُّلالِ بعَلّةٍ
وتنْعَمَ في تِلْك الظِّلالِ بتَعْريسِ
لم تكن بادس منفى، بل فسحة ثانية للانتماء والكتابة، التقى فيها الأحرار بالعلماء، وازدهرت فيها المعاني رغم هدير السفن. وحتى إن طُمست معالمها، فإن البحر ما زال ينقل في زفراته ذكرى مدينة لم تمت، بل اختبأت خلف الصخرة تنتظر من يُنصت.

ذاكرة العلم والمحراب
حين نذكر بادس، لا نستحضرها كمدينة مطمورة فحسب، بل كمنارة أشعت زمنها بالعلم والصلاح. فيها وُلد أبو يعقوب الباديسي يوم 17 ذي الحجة 640هـ، وتربّى بين حناياها مشبعًا بنور الفقه والزهد. وقد نزل بها فقيه المالكية عبد الملك بن حبيب، وتوافد عليها العلماء من سبتة وغيرها، مثل أبي البركات البلفيقي والخضار السبتي، يطلبون العلم أو يتبركون بمقام الولي. وعلى هامش المدينة، حيث تلامس الصخرة البحر، اعتزل أبو يعقوب الناسك في الرابطة القديمة، يمارس التحنث والانقطاع، تاركًا وراءه مسار العارفين.
وإذا كانت بادس قد شهدت الصراع والمنفى، فإن "زهيلة" أو "اسهيلة"، البادية الواقعة بين آيت ورياغل وآيت يطفت، كانت امتدادها الروحي البعيد. من هذه الأرض خرج قضاة وعلماء وتجار أسهموا في بناء إشعاع المدينة. نقرأ عنهم في "المقصد الشريف" و"الوسيلة إلى المرغوب"، ونصادف آثارهم في الذاكرة الشفوية والأنساب. لم تكن زهيلة نقطة عبور فقط، بل قلبًا خفيًا نابضًا خلف الواجهة البحرية، ومسلكًا باطنيًا نحو الصلاح والمعرفة، شكّل الامتداد الطبيعي لبادس من الداخل.
في هذا النسق الروحي، نبغت سلالة "الزهيليين"، التي حملت مشعل العلم والتقوى. من بينهم يوسف بن محمد الزهيلي، الولي والعارف، والمجاهد أحمد بن يحيى الذي عبر إلى الأندلس، وقاضي الموحدين أبي تميم الزهيلي، والشيخ علي بن محمد النعجة إمام مسجد المقبرة ببادس، وعبد الله بن محمد، صاحي مخطوط "معنى البسملة وإعرابها" والحاج الحسن البادسي الزهيلي. هؤلاء وغيرهم عاشوا بين بادس وزهيلة، مرورا ب "ثرا ن ثيزي عري" يسقون الأزمنة الصعبة بحكمة العارفين، ويؤسسون لصوت خافت... لكنه لا ينطفئ.

حين تهمس الأطلال بالنداء
قد تبدو بادس اليوم نقطة هامشية على الخريطة، شاطئا منسيا في أقصى الشمال، بلا لافتة ولا تذكار، لكنها في الحقيقة جرح مفتوح في ذاكرة الوطن، وصفحة طُويت قبل أن يُكتب فيها كل شيء. الصخرة التي تعلوها الراية الأجنبية ليست مجرّد أثر استعماري، بل مرآة لصراع أطول بين النسيان والتاريخ، بين السيادة المُعلّقة والذاكرة التي تأبى المحو. هنا، لا تتكلم الحجارة، لكنّها تهمس بما لا يُقال، ولا يزهر النسيان في الرمل، لأن كل حبة فيه تخبئ سيرة من عبر، ومقام من صمت.
ليس المطلوب أن نحزن على ما مضى، بل أن نعيد الإصغاء لما تبقّى. فبادس ليست ماضٍ انتهى، بل سؤال ممتدّ في الحاضر: عن جدوى الكتابة في زمن المحو، وعن دور الذاكرة حين تُهمّش الجغرافيا. وحدها العيون التي ترى بأثر القلب، قادرة على استعادة المكان كقيمة لا كموقع. فهناك، عند حافة الماء، لا يزال البحر يروي... ومن يُنصت جيدًا، قد يسمع بين الأمواج اسمًا ظل حيًّا، ولو في صمت الصخور: بادس..

 رئيسية
رئيسية 








 الرئيسية
الرئيسية